العبادات الإسلامية فيها بعد اجتماعي واضح، ولعل أبرز هذه العبادات وضوحاً الحج، إذ أن المسلمين يحجون إلى بيت الله الحرام في زمن واحد، ويجتمعون على صعيد واحد.
ومن البرامج العبادية المهمة، ذات الطابع الاجتماعي: صلاة الجماعة، يقول تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾[16] .
والتي يتّفق جميع المسلمين على أصل تشريعها في جميع الصلوات الواجبة، كما يتفقون على عدم صحة صلاة الجمعة والعيدين ـ في حال وجوب صلاة العيدين ـ إلاّ جماعة.
ووقع الخلاف بين الفقهاء في حكم صلاة الجماعة في الفرائض اليومية، والآراء في حكمها ثلاثة:
الأول: واجبة فرض عين: وهو رأي المذهب الحنبلي وبعض الأحناف[17] .
الثاني: واجبة فرض كفاية: وهو رأي الشافعية[18] .
الثالث: سنّة مؤكّدة:وهو رأي الجعفرية[19] ، والمالكية وبعض فقهاء الحنفية[20] .
هذا وقد وردت أحاديث وروايات كثيرة تؤكّد على أهمية صلاة الجماعة، ومنها ما جاء عن رسول الله في حديث ذكرته المصادر من الفريقين: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة»[21] أوكما في صحيح مسلم «صلاةٌ مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده»[22] .
و ورد عن الإمام الباقر أنه قال: «من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له»[23] .
وكذلك ورد عن الإمام الصادق: «مَنْ لم يصلِّ جماعة فلا صلاة له بين المسلمين، لأن رسول الله قال: لا صلاة لمن لم يصلَِّ في المسجد مع المسلمين إلا من علة»[24] .
وقد سأل زرارة الإمام الصادق: عن ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة، فقال: «نعم، صدقوا»[25] .
وعنه : «إن الله يستحي من عبده إذا صلّى في جماعة ثم سأله حاجته أن ينصرف حتى يقضيها»[26] .
وفي هذا المجال ينقل الشيخ الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين): روي أن السلف كانوا يعزّون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى، ويعزون أنفسهم سبعاً إذا فاتتهم الجماعة[27] .
وقد تحدث الفقيه المعروف السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى عن الترغيب في صلاة الجماعة بشكل تفصيلي ومن عباراته ما يلي: (هي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصاً اليومية منها وخصوصاً في الأدائية، ولا سيّما في الصبح والعشاءين، وخصوصاً لجيران المسجد أومن يسمع النداء، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات) إلى أن قال رحمة الله (وكلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد، ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافاً بها... فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر سيما مع الاستمرار عليه، فإنه كما ورد لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها)[28]
فوائد صلاة الجماعة
لصلاة الجماعة فوائد جمّة في حياة المسلمين، نذكر منها:
1. تعزيز الحالة الدينية
حينما يحضر المسلمون المسجد ويصلون مع بعضهم البعض تتعزز الحالة الدينية في نفس كل واحد منهم وتتقوّى، فمن طبيعة الإنسان أنه عندما يرى كثرة من الناس تمارس عملاً معيناً يعطيه ذلك دافعاً للقيام بهذا العمل الذي يجد الآخرين يقبلون عليه، فالعمل الجمعي له وقع وقيمة في النفوس، وبما أن صلاة الجماعة هي في الأصل أداء للواجب والتكليف الشرعي ومظهر من مظاهر التديّن، فتعزيزها تعزيز للحالة الدينية الاجتماعية. وهذا هو ما أشار إليه الإمام علي الرضا بقوله: «إنما جعلت الجماعة لئلا يكون الإخلاص والتوحيد والإسلام والعبادة لله إلا ظاهرًا مكشوفًا مشهورًا، لأن في إظهاره حجّة على أهل الشرق والغرب»[29] .
2. تأكيد التداخل بين اتصال العبد بالله وصلته بالناس
فالمصلي عندما يأتي للجماعة في المسجد ينوي الصلاة مخلصًا لله سبحانه، ولكنه يؤديها مع جماعة المؤمنين، وهذا يؤكّد ـ وبشكل جليّ ـ أن للدين بعدين، البعد العبادي المتعلّق بالصلة بالله تعالى، والبعد الاجتماعي المتعلّق بعمق العلاقة بين الفرد وبني مجتمعه.
3. توثيق الروابط الاجتماعية
ففي صلاة الجماعة يلتقي المؤمنون ويتعرف بعضهم على بعض، وتكون فرصة للتلاقي اليومي وتبادل الأحاديث والأوضاع الاجتماعية، كما يعيش المصلون حينما يقفون خلف إمام واحد وبجانب بعضهم بعضاً حالة من المساواة وانعدام الطبقية بين مختلف فئاتهم وشرائحهم، وهو أمر يعزز حالة التوادّ والمحبة بين الناس.
4. التربية على النظام
صلاة الجماعة تربي الإنسان على النظام والانضباط الجماعي، فإذا واظب المصلي على الجماعة، فسينضبط في أداء الصلاة في وقتها، وعلى العكس من ذلك الصلاة فرادى، حيث لا يكون هناك أي مُلزم لأدائها في وقتها.
وفي الجماعة تعويد على النظام، حيث يكبر المأمومون بعد الإمام ويؤدون جميع أفعال الصلاة بعده، إلى أن تنتهي الصلاة ويقفون صفوفا منتظمة متراصة.
5. التوجيه والمعرفة الدينية
توفر صلاة الجماعة فرصة جيّدة للتوجيه والمعرفة الدينية، حيث يستفيد المصلون من حضورهم للصلاة باستماع الخطب والمواعظ الدينية وعرض أسئلتهم واستفتاءاتهم الدينية على إمام الجماعة إذا كان من أهل المعرفة والعلم.
العزوف عن صلاة الجماعة:
وقد يتساءل البعض: ما دامت لصلاة الجماعة هذه الفوائد والآثار الطيبة على المجتمع، إضافة إلى ما ورد من النصوص الدينية في الحث عليها وتبيين عظيم ثوابها عند الله تعالى، فلماذا نجد العزوف عند الكثيرين من حضورها، حيث لا يمثل الحضور لصلاة الجماعة إلا نسبة قليلة محدودة من المجتمع؟
لابدّ أن هناك أسباباً لعل من أبرزها ما يلي:
الأول: ضعف الاهتمام الديني:
فمن يهتم بتعاليم الدين لا يترك صلاة الجماعة، إذا كان عارفاً بقيمتها وفضلها عند الله، ومن يرغب في ثواب الله تعالى، لا يتأخر عن صلاة الجماعة، مع ما ورد فيها من الأجر العظيم والثواب الكبير.
لكن يبدو أن الكثيرين يفتقدون رغبة الإقبال على هذه الشعيرة العظيمة، بسبب ضعف الاهتمام الديني في نفوسهم.
الثاني: ضعف التشجيع:
حيث لا نجد في المجتمع حثاً وتشجيعاً كافياً على أداء صلاة الجماعة، فالكتابات حولها قليلة، والخطباء نادراً ما يتعرضون لفضل صلاة الجماعة ولحث الناس على المواظبة عليها.
بل إن بعض الخطباء وطلاب العلوم الدينية قلّ أن يرى الناس حضورهم في صلاة الجماعة في ماعدا تصديهم للإمامة، وكأن طالب العلم لا صلة له بهذه الشعيرة إلا إذا كان إماماً وليس مأموما.
الثالث: الكسل
إن قسماً من الناس يستثقل الذهاب إلى صلاة الجماعة، لأنها تأخذ جزءاً من وقته، وتصرف شيئاً من جهده، فيرى صلاته منفرداً في البيت أسهل وأيسر، مع أن الوقت والجهد اللذين تستلزمهما صلاة الجماعة محدود ضئيل، وهو يصرف أضعاف ذلك الوقت والجهد على سائر شؤون حياته من الكماليات والرفاهيات.
الدعوة لصلاة الجماعة:
يحتاج مجتمعنا إلى حملة مكثفة من التوعية والتوجيه لحث الناس على صلاة الجماعة، بنشر الكتب والمقالات التي تتناول فضلها وأهميتها، وينبغي أن تفتح المنتديات على مواقع الانترنت باب النقاش والبحث حول أسباب العزوف عن صلاة الجماعة في المجتمع، وطرق التشجيع على المواظبة عليها، والعلماء والخطباء عليهم أن يكرروا الدعوة إليها والحث على الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة.
ويمكن الاستفادة من الجوال، بإرسال رسائل قصيرة إلى الأصدقاء والأقرباء، لدعوتهم لصلاة الجماعة.
ولو تشكلت في كل مسجد لجنة للدعاية والإعلام لصلاة الجماعة، وابتكار الوسائل والأساليب المؤثرة في جذب الناس لها، فإنها ستحقق نتائج جيدة.
وعلى كل فرد منا أن يحث ويشجع أقرباءه وأصدقاءه، ولا يسأم من دعوتهم لصلاة الجماعة، فإن الدال على الخير كفاعلة. وذلك مصداق من مصاديق الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف.
وأما شرط العدالة الذي يشترطه الإمامية في إمام الجماعة فليس بمستوى التعقيد الموجود، وهي لا تعني العصمة، بل تعني أن لا يفعل الإمام المحرمات ويترك الواجبات، يقول السيد اليزدي: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر، وعن منافيات المروّة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلك الملكة[30].
وقد ترتفع العدالة عن إمام الجماعة بفعل المحرّم وتعود إليه بالتوبة، يقول السيد السيستاني: ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم[31] .
ويكفي في إثبات العدالة للإمام شهادة عادلين، قال السيد اليزدي في العروة الوثقى ووافقه السيد السيستاني ما يلي: بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وكذلك إذا حصل من اقتداء عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به[32] ، وهناك بعض المذاهب الإسلامية لا يرون شرط العدالة.
وأسوأ ما في الأمر أن ترتبط صلاة الجماعة في مجتمعنا بالانتماءات وبمراجع التقليد والتي لا دخل لها في صلاة الجماعة، ولا تؤثر على إمام الجماعة لا من قريب ولا من بعيد. والقصص في هذا الجانب كثيرة: وقد كنا في مجلس المرجع الراحل الإمام الشيرازي (رحمه الله) ووجّه إليه سؤال من الحاضرين قالوا: سيدنا في مجتمعنا إمام مسجد عادل، ولا نجد عليه مأخذا سوى أنه يُعلن أن تقليد سماحتكم غير جائز، فهل نُصلّي خلفه؟ السيد أجابهم: إذا كان ما يتحدث به عن قناعة، وهو يُبّر بذلك عن رأيه، فهذا لا يخدش عدالته، فلا مانع من الصلاة خلفه.
ورائع جداً موقف الفقيه المحدّث الشيخ يوسف البحراني صاحب (الحدائق الناضرة) توفي سنة 1186هـ، والذي كان على خلاف شديد مع العلامة الشيخ محمد باقر الشهير بالوحيد البهبهاني، في موضوع الأصوليين والإخباريين، فالشيخ البحراني زعيم مدرسة المحدثين الإخباريين، والوحيد البهبهاني، زعيم المدرسة الأصولية، وكان يردّ آراء الشيخ يوسف بعنف، ووصل به الأمر إلى أن أفتى ببطلان الصلاة خلف الشيخ يوسف البحراني، لكن الشيخ يوسف أفتى بصحة الصلاة خلف الوحيد[33] . والعجيب أنه في وصيّته أوصى بأن الذي يُصلي خلف جنازته هو الشيخ البهبهاني.
وفي الأخير تجدر بنا الإشارة إلى أن صلاة الجماعة لا تقتصر على أن يكون إمام الجماعة من مذهبك، حيث أفتى فقهاؤنا بأنك إذا كنت في مكان أقيمت فيه صلاة الجماعة لأخوانك المسلمين، وإن لم يكونوا على مذهبك فعليك بالمشاركة معهم في صلاة الجماعة حيث تقرأ لنفسك الفاتحة والسورة، وأي حكم يختلف عنهم كالتكتف والسجود على ما لا يصح السجود عليه في المذهب لك أن تتركه إذا كان في التزامه حرج، وصلاتك صحيحة ومجزية، من هنا لا ينبغي الخروج من المسجد الحرام، أو المسجد النبوي وقت صلاة الجماعة، كما لا ينبغي لمن يعمل أو يتواجد في أي مكان أن ينفرد بصلاته عند أقامة الجماعة.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمدٍ وآله الطاهرين



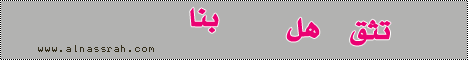






 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس






المفضلات