الشيخ/ حسن الصفار
في أولى ليالي عاشوراء، الشيخ الصفار يتحدث عن أهمية تذكير جمهور المسلمين بيوم عاشوراء كيومٍ من أيام الله
للإستماع اضغط هناا
يتركّز حديثنا هذه الليلة ـ من خلال الآية ـ في المحورين التاليين:
المحور الأول: أهمية التذكير بأيّام الله
لفهم المقصود بِـ «أيام الله» الوارد في الآية الكريمة، لابدَّ من التمهيد لذلك ببحث لفظة «اليوم» علميًّا وعرفيًّا.
تحديد معنى اليوم:
اليوم ـ علميًّا ـ: يعرّف بأنه المدّة الزمنيّة التي تستغرقها الأرض للدوران حول نفسها، والتي تمتدّ لأربعٍ وعشرين ساعة.
بينما اليوم ـ عرفًا ـ: ما يقابل الليل، حيث يبدأ اليوم من شروق الشمس وينتهي بغروبها. فيقال في كثير من أدبيات العرب: اليوم والليلة، و«مسير يومٍ وليلة». وقد وردت بعض الأحاديث الشريفة تستعمل اليوم في هذا المعنى. وقد صنّفت بعض كتب الأدعية فيما يسمّى بِـ «أدعية اليوم والليلة»، بينما في الحقيقة فإن الليل يقابله النهار، ومن الليل والنهار يتكون اليوم الواحد.
بداية اليوم:
اختلفت الشعوب والمجتمعات في تحديد بداية اليوم:
-فالعرب ـ وبالتالي عند المسلمين ـ واليهود يعتبرون أن بداية اليوم من غروب الشمس، فتكون بداية الليل هي البداية الفعلية لأي يوم، ليكون غروب شمس ذلك اليوم هو آخر أوقاته، والساعة ما قبل الغروب هي آخر ساعات ذلك اليوم.
- بينما ما عليه الرومان والأوروبيون الآن أن بداية اليوم تكون من منتصف الليل.
نسبة الأيام إلى الله تعالى:
في الآية الكريمة توجيه إلهي للنبي موسى بأن يذكّر قومه بِـ «أيام الله»، فما المقصود بهذه الأيام؟
الأيام من ناحية زمنية كلها أيام الله، فهو سبحانه خالق الزمان والمكان، وخالق كل ما يحيط بنا في هذا الكون الفسيح.
ولكنّ نسبة أمرٍ مّا إلى الله تعالى يدلّ على تشريفه وتعظيمه، وذلك كنسبة بعض الأمكنة لله، كالمسجد الذي يطلق عليه أنه بيت من «بيوت الله». وكذلك شهر رمضان الذي يطلق عليه أنه «شهر الله».
وقد اختلف المفسّرون في المقصود بِـ «أيام الله» الواردة في الآية الكريمة على ثلاثة أقوال:
(1) فقال بعضهم أن «أيام الله» هي تلك الأزمنة والأيام التي انتصر الله تعالى فيها لأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، وذلك لما تحقق فيها من عزّة لدين الله ونصر لأوليائه ولقيم الحق. وعلى هذا يكون معنى الآية: ذكرهم بأيام انتصارات الأنبياء والمؤمنين على أولئك الطغاة المعاندين.
(2) بينما يرى بعض المفسرين أن المقصود بِـ «أيام الله» تلك الأيام التي حلّت فيها نقمة الله وغضبه على الكافرين الظالمين الذين كانوا يصرّون على معاندة ومناوأة أنبياء الله وعباده الصالحين، وذلك لما في هذه الأيام من ظهور لمقدرة الله وبطشه ونكاله بهؤلاء الظالمين المعتدين في الأرض.
(3) ورأى بعض المفسرين أن المعنى أشمل من هذين الموردين، فكل يوم حصل فيه حدث مصيري في تاريخ البشرية أو تاريخ مجتمع من المجتمعات فإن ذلك اليوم يعتبر من أيام الله، وذلك لما في هذه المناسبات والأيام من عِبَر ودروس ومواعظ يتعلّم منها الإنسان وتتعظ منها الشعوب والمجتمعات.
وعلى هذا الرأي يكون معنى الآية الكريمة أن الله تعالى يوجّه نبيّه موسى ويأمره بأن يذكّر قومه بهذه الأحداث والمواقف التي حصلت فيها تطوّرات مهمّة وتحوّلات مصيرية في تاريخهم، كانتصارهم على الطاغية فرعون حينما أهلكه الله تعالى مع جنوده.
وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: «كان رسول الله يخطبنا فيذكّرنا بأيام الله»[2] .
وهذا يدلّ دلالة واضحة على أن هذا التعليم الربّاني ممتدّ مع بقية النبوّات، ليكون سِمَة بارزة في حياة المجتمعات المتديّنة، يتذكّر أفرادها ومجموعاتها تلك الأيام التي يجد فيها الإنسان ما يتّعظ به ويفيده في حياته العملية، وقال الفخر الرازي: إنه يعبر بالأيام عن الوقائع العظيمة التي وقعت فيها، يقال: فلان عالم بأيام العرب. ويريد وقائعها[3] .
إقامة الذكرى عرف اجتماعي:
وقد أصبح متداولاً ومعروفًا اليوم في المجتمعات البشرية أنها تهتمّ بأيام ذات أحداث مصيرية وتاريخية مهمّة.
فأغلب الدول تحتفي بيوم استقلالها وتحرّرها من نير الاحتلال الأجنبي، وأصبح هذا الأمر تقليدًا دوليًّا، لا تكاد ترى دولة في العالم لا تحتفل بيوم استقلالها، وتجعله يومًا وطنيًا ويومَ عطلة. كما أن لكل دولة أو أمّة من الأمم أيامًا تحتفي بها رسميًّا وشعبيًّا. فالفرنسيون ـ مثلاً ـ يحتفلون بيوم سقوط الباستيل، ذلك السجن الذي كان رمزًا للظلم والطغيان.
وقد تعارفت بعض المجتمعات البشرية على تخصيص بعض الأيام لتكريس وتأكيد بعض القيم والاهتمامات الجيّدة، وذلك مثل يوم «عيد الأم». الذي هو عرف وتقليد قديم عند المجتمعات الأوروبية من القرن السابع عشر الميلادي، كيوم يتذكّر فيه الناس فضل الأم وتضحياتها ويجدّدون عهد التقدير والاحترام للأم، لما تتحمّله من عناء وبما تفيضه على الأبناء من محبّة وعطف في الحمل والرضاع والتربية.
أهمية التذكير بأيام الله:
للتذكير بالأيام المفصلية في حياة كل أمّة أهمية عظيمة تنطبع على واقع الأمة ومستقبلها، وذلك:
(1) من أجل أن ترتبط المجتمعات البشرية بتاريخها وتستفيد من التجارب والدروس والعبر التي حصلت في تلك الوقائع والأحداث السابقة، وإلاّ لو لم يكن هذا التركيز لكانت معرفة تلك الوقائع خاصّة بأولئك المعنيين بأمور التاريخ والأبحاث التاريخية فقط. لذلك فإن إعلانها والتذكير بها وطرحها بشِكْل عام يلفت أنظار الجميع، وبالتالي يستفيد الجميع من عبرها وتجاربها.
(2) ومن ناحية ثانية تكون إقامة ذكرى هذه الأحداث تخليدًا لمن قام بتحقيقها، فالبطولات التي تأسست عليها حضارات الأمم والشعوب يقف وراءها أبطال، تكون هذه الاحتفالات تخليدًا لذكراهم وتلمُّسًا لمواقع البطولة والتميّز لدى هؤلاء الأفراد أو هذه المجموعات.
برامج التذكير بأيام الله بين المنع والقبول:
في الآية القرآنية الكريمة يأمر الله تعالى نبيّه موسى بتذكير قومه بأيام الله، فالقرآن هنا لم يضع كيفية معيّنة بها يتحقّق هذا التذكير، ولكنّ ما عليه كثير من الأمم والشعوب أن يتم ذلك عادةً من خلال الاحتفال الشعبي وما يصاحب ذلك من إدخالٍ لبعض التقاليد والأعراف في إحياء هذه المناسبات التي ـ غالبًا ـ ما تقام سنويًّا.
والاحتفاء بالمناسبات الدينية أو الاجتماعية بهذه الطريقة قد تحفَّظت عليها بعض المدارس الإسلامية، وهي المدرسة السلفية، فهم يرون أن الاحتفال بشِكْل منتظم ومبرمج بأي مناسبة ـ تاريخية أو اجتماعية أو دينية ـ غير مشروع وبدعةً في الدين.
ولذلك كان هناك ممانعة في الاحتفال باليوم الوطني في المملكة داخل البلاد ضمن مظاهر رسمية، فقد كان ذلك ممكنًا في سفارات المملكة في الخارج، ولكن لم يكن ممكنًا بسبب التحفّظ الديني الذي كان يبديه بعض علماء هذه المدرسة.
ولكن حينما أصبح هناك ضرورةَ أن يعيش الناس في هذا البلد الانتماء إلى وطنهم وأن يشعروا بقيمة هذا الكيان وحبّه وأن تكون هناك هويّة مشتركة يجتمع فيها المواطنون ويلتقون فيها عاطفيًّا ما عادت تظهر تلك المعارضة التي كانت في الماضي.
وهذا الرأي (التحفّظ في إقامة الاحتفالات الدينية أو الاجتماعية أو التاريخية) يبقى رأي مدرسة معينة، والغالبية الساحقة من المسلمين وفقهائهم لا يرون هذا الرأي، ونجد ذلك واضحًا في إقامة ذكرى المولد النبوي الشريف الذي تحتفل به معظم البلاد الإسلامية، وتعتبره عطلة رسمية ومناسبةً مهمّة يجدّدون فيه الولاء لرسول الله ويتحدّثون عن سيرته وتاريخه ويجدّدون العهد بتعاليمه.
ولو دارت المسألة في إقامة الاحتفالات والمناسبات الدينية في إطار اختلاف الرأي لا مانع من ذلك، فلكل طرف رأيه واجتهاده وقناعته، ولا يصحّ أن تتحوّل هذه المسألة إلى صراع وصدام
.
المحور الثاني: عاشوراء نموذجًا
في تاريخنا الإسلامي وقائعُ لها أهمية ومنعطفاتٌ تشكّل لحظات مصيرية في تاريخ الأمة، وتؤثّر على وجدانها وثقافتها وعلى واقعها الاجتماعي والسياسي. هذه الأحداث يمكن أن تكون مصداقًا لعنوان «أيام الله» الوارد في القرآن الكريم.
ويمكننا ـ بكل ثقة ـ أن نعتبر «عاشوراء» مصداقًا بارزًا من بين تلك الأحداث، وذلك لما تحفل به هذه الحادثة من دروس وعبر وقيم للأمة وجماهيرها الواسعة.
«عاشوراء» مصطلح إسلامي:
يشير بعض علماء اللغة إلى أن مصطلح «عاشوراء» مصطلح إسلامي لم يكن في الجاهلية. هذا ما أكّده ابن الأثير في النهاية وابن دريد في الجمهرة.
ويُقْصَد به اليوم العاشر من المحرّم، ولا يطلق على أي يوم عاشر من أي شهر غير المحرّم.
وهناك من يرى أنه ـ كمصطلح ـ كان متداولاً قبل الإسلام، ويروون في ذلك بعض الروايات في صحيحي البخاري ومسلم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: «فأنا أحق بموسى منكم». فصامه وأمر بصيامه[4] .
وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فُرض رمضان، كان من شاء صام، ومن شاء أفطر[5] .
كان ذلك قبل فرض صيام شهر رمضان، فلمّا فُرِض صيام شهر رمضان أصبح صوم يوم عاشوراء ليس مفروضًا على المسلمين، وإنما اعتبروه مستحباً.
ولكنّ مدرسة أهل البيت لا تقبل هذه الأحاديث ولا ترى صحّتها من ناحية السند وتناقش أيضًا في المضمون، وتذهب هذه المدرسة إلى أن هذا المصطلح يظل مصطلحًا إسلاميًّا تعارف المسلمون عليه بسبب الواقعة التي حصلت فيه باستشهاد الإمام الحسين في ذلك اليوم.



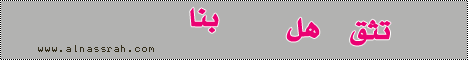







 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
المفضلات