أحداث تاريخية
واقعة الحصارة واقعة الطف
واقعة الشربة
سنة الضرائب سنة البطاقة سنة الطبعة
واقعة الشربة 1326هـ
تعد واقعة الشربة من أكبر المعارك التي خاضها أبناء القطيف فقد سادة جميع قرى ومدن القطيف وقد نالت القديح الحظ الأوفر منها ، إن الأصل في واقعة الشربة على روايات متقاربة ، فالرواية التي أوردها المرحوم فضيلة الشيخ فرج العمران رحمه الله في الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية عن بداية وقعة الشربة فهي الرواية المتداولة بين الناس بأن بداية الواقعة كانت أمتناع أحد البداة عن دفع ثمن الماء الذي شربه الى السقاة صاحب الشربة أوالجرة ، أما رواية محمد سعيد المسلم فتختزل بدايتها باعتداء أحد البداة على أحد السقاء المتجول ، ونتيجة لذلك وظروف أكتنفت المنطقة ، قد مهدت السبيل لانفجار واقعة الشربة والتي بدورها شملت قرى ومدن القطيف فراح ضحيتها الكثير
روايتان عن «وقعة الشربة»
إن الرواية التي أوردها الشيخ فرج العمران عن بداية «وقعة الشربة» وبعض تطوراتها، هي رواية متداولة بين الناس، إلى جانب رواية أخرى، تقول بان بدايتها كانت امتناع أحد البداة عن دفع ثمن الماء الذي شرب إلى السقاء صاحب «الشربة» أو «الجرة» وليس رمي الجرة المنكسرة قريباً من البدوي. أما رواية محمد سعيد المسلم فتختزل بدايتها باعتداء أحد البداة على السقاء المتجول وهذا اختلاف بسيط لا اهمية له على كل حال، لأن هذا الحادث لا يعدو أن يكون القشَّة التي قصمت ظهر البعير، لا بد وان ثمة مقدمات أو ظروفاً اكتنفت المنطقة، قد مهدت السبيل لانفجار «وقعة الشربة».
الدبابية وليس القلعة
أما الرواية الأخرى التي أوردها مهدي السويدان على صفحات مجلة «المنهل» السعودية عن «وقعة الشربة» وبعض تطوراتها، ونقلها عنه عبد العلي السيف ، فوجدت بعد اطلاعي عليها في كتابه، شيئاً من الغموض. انه يتحدث عن خطة ارتآها الحجة الشيخ محمد بن نمر، ونفذها أهل القطيف في فك الحصار، وهي تتعارض مع رواية أخرى سمعتها منذ مدة طويلة عن الاسلوب الذي تم في فك الحصار عن «القلعة». كذلك فان معرفتي بان الحجة الشيخ ابن نمر من أهالي العوامية ويتردد على « الدبابية » لأنه متزوج من امرأة من إحدى اسرها، قد عزز ظني بأن المقصود بالحكاية «الدبابية» دون سواها.
فك حصار القلعة
أما عن فك الحصار عن القلعة، فقد أعلم أهالي القلعة ليلة 18-7-1326 هـ أي بعد مضي شهرين على أحداث «وقعة الشربة» بأن الشيخ سوف يخرج في اليوم التالي من أجل طرد المحاصرين، فمن شاء فليجهز نفسه.
وفي اليوم التالي خرج الشيخ متقلداً سيفاً، في جمع من أهالي القلعة يصحبه أبوه الحاج حسنعلي بن حسن الخنيزي، وأخوه جعفر واحمد، واستطاعوا بفعل المفاجأة والتصميم أن يدحروا المحاصرين ويطاردوهم حتى حدود قرية «الخويلدية»، وفيها قتل جعفر وجرح أحمد في يده وكان على وشك أن يجهز أحد البداة عليه بعد إصابته، لولا أن أنقذه أحدهم وكان له به معرفة، وحمله معه إلى ديارهم وأخرج الرصاصة من يده وداواه مدة ثلاثة أيام، ثم أتى به إلى القلعة، بعد أن أخذ له الأمان من أهلها، فأكرمه أبوه الحاج حسنعلي الخنيزي واحتفى بعودة ابنه.
لكنا لا نعلم ان كانت هذه المعركة هي خاتمة حصار القلعة في «وقعة الشربة» أم ان الحصار ضرب عليها من جديد، ذلك ان هذه الحرب التي طالت بنارها بلدات وقرى وضواحي القطيف قد دامت حوالي 6 أشهر
واقعة الطف 1326هـ
وقعة الطف» سنة 1326 هـ في القديح، حيث حارب القديحيون وحدهم «باستثناء عدد من المتطوعين من أهالي العوامية الذين حاربوا إلى جانبهم» والأمر نفسه تكرر في «وقعة الجبل» في العوامية سنة 1330 هـ، وكذلك «وقعة سيهات» التي ربما كانت سنة 1329 هـ «وقد انضم أيضاً إليهم عدد من متطوعي العوامية». بل هكذا على الأرجح كان الحال في «وقعة الشربة» سنة 1326 هـ نفسها: كل ضاحية وقرية وبلدة أخذت تدافع عن نفسها بمعزل عن الآخرين، ولا يغير من الأمر شيء كون القلعة قد استقبلت أثناءها النساء والأطفال والعجزة من قرية البحاري وضواحي الحاضرة.
في "وقعة الطف" هاجم فخذ إحدى القبائل البدوية القديح من جهة الغرب، وهي أرض مرتفعة آنذاك عن مستوى البلدة، فتحصن الأهالي المسلحون وراء أشجار نخيل "الطف" المحاذية لذلك المرتفع من الأرض، ودارت بينهم المعركة طويلا (حوالي 3 أيام) دون أن يكل القديحيون أو ينتصر المهاجمون، رغم تميز موقعهم المرتفع.
وأثناء ذلك كان رجال من القبيلة نفسها مجتمعين في حاضرة القطيف بأحد زعماء القطيف في العهد التركي، من غير العلماء، حيث طلب منهم الأخير بيع أملاكهم (بساتين النخيل) في القطيف ومغادرتها، وكان مؤيدون له من أهالي القطيف والعوامية يطلقون الرصاص في الجو، حول مكان الاجتماع، ثم خرجوا غير متفقين فتوجه البداة فوراً إلى القديح عبر الطريق المؤدي إليها من القطيف، فلما وصلوها ظنهم القديحيون من أهالي القلعة لعدم توقع مجيء مهاجمين لهم من هذا الطريق، وكذلك لتماثل ثيابهم وثياب القلعاويين، فتنادى القديحيون إلى التوقف عن إطلاق النار، وبسرعة انقض عليهم البداة بالرصاص من الخلف. هكذا فعلت الخديعة والمفاجأة فعلهما.
واقعة الحصارة1326هـ:
توجد رواية موحدة عن "وقعة الحصارة" بالقديح تقول بحدوثها سنة 1326 هـ. وفيها حاصر البدو بلدة القديح المسورة، وكانت امتداداً "لوقعة الشربة"حيث قاتل القديحيون من وراء الاسوار.
وقعة الجبل بالعوامية
أما «وقعة الجبل» سنة 1330 هـ ، فقد استدرجت إحدى القبائل البدوية أهالي العوامية إلى خارج البلدة وخارج بساتينها، في مكان يدعى «جبل القوم» يوجد فيه مرتفع صخري، مستغلة في ذلك حماستهم واندفاعهم لرد العدوان عن بلدتهم، وكان البداة متمترسين وراء الصخور، فأصبح بعض المحاربين من أهالي العوامية مكشوفا للرماة وهو الذي تعرض للإصابات أكثر من سواه. أما البعض الآخر فقد تمترس وراء الصخور في جهة أخرى، كما فعل البداة، وشكل جبهة أخرى ضدهم فاحدث بين صفوف البداة خسائر. وآخرون من أهالي العوامية ظلوا يقاتلون محتمين بالنخيل.
وقد اختلفت الروايات في تحديد عدد القتلى، فإحداها تقول إن العوامية فقدت 21 قتيلاً، وروايات أخرى ترفع العدد حتى يبلغ عند أحدهم 70 قتيلاً، ومثلهم من البداة. وقد أحصى أحد المهتمين المعاصرين 22 اسما من قتلى العوامية. إلا أن عددا كهذا لا يعتبر ضئيلا بمقياس المعارك ومقياس عدد سكان الحواضر والبوادي المتواضع في الجزيرة العربية في ذلك الزمان.
سنة الطبعة 1344 هـ :
سنة الطبعة التي حدثت في الساعة الثانية عربي ليلة الجمعة 13/3/1344 هـ في نهاية صيف ذاك العام حيث كانت قبل قفال الغوص بيومين اثنين فقط أي في نهاية موسمه السنوي حيث عصفت في ذلك الوقت عاصفة هوجاء أو اعصار شديد لا اعادهما الله على الناس جميعاً ، وقد استمرت نصف ساعة كما يقول الأباء ولكن خلفت من ورائها الدمار الكبير في القطيف لما اهلكته من الحرث والنسل ، وخربت كثيراً من الممتلكات والزراعة وقتلت كثيراً من الناس لأن معظم الأهالي كانوا يعملون في مجال الغوص، ومحاملهم كانت آنذاك شراعية ولوجود الكثير في بحر القطيف ممن كانوا يمارسون الغوص والملاحة البحرية من الكويت والبحرين وقطر وعمان فقد صارت الكارثة شبه عامة على بلدان الخليج ، حيث إن اكثر المحامل طبعت والناس الذين فيها أكثرهم غرقوا ، إضافة إلى سقوط الآلاف من النخيل وقلع ما يقل عن إعدادها من الأشجار وهدم المنازل المتصدعة وطيران الأكواخ من محالها ، ولم تجد في تلك الليلة إلا النوائح من كل مكان على من كان في البحر ، ولما هدئت العاصفة ذهبت جميع النساء والأطفال ومن في البلاد من الرجال إلى ساحل البحر وهم يبكون متطلعين إلى إخبار أهليهم وسلامة من نجا منهم ، مما جعل مردوده السي يطلق على هذا العام بسنة الطبعة لكثرة من طبع فيها من المحامل والناس الذين خسر بعضهم حياته وأزهقت في البحر روحه غرقاً ، وما أصاب البلاد من جراء ذلك الإعصار من خسارة فادحة في الأرواح والممتلكات التي تسببت في تعطيل الطاقات والإمكانيات بسبب موت الشباب وفقد عدد غير قليل من المحامل التي كان الناس يتسببون بواسطتها في البحر في صيد الأسماك والغوص ونقل البضائع من البحرين ، ومما عمله الإعصار من فساد المحصولات الزراعية وتخريب الأراضي فساد المحصولات الزراعية وتخريب الأراضي المزروعة أو افساد الزراعة فيها والقضاء على محصولها في ذلك العام الذي عرف بعام الطبعة، وما من شك ان الإنسان إذا فقد وسائل العمل لا يكون بخير أبداً ، ولذلك أخذ الغوص في الانحدار وتوجهت الناس للأعمال في البر لدى شركة ارامكو بأجر يومي قدره لغير الفني ريالاً إلا ربعاً هرباً من البحر وأهواله وطلباً للراحة والاستقرار وإسهاما منه في النهضة للبلاد من ثروة إنتاجية النفط ومشتقاته وتعمير البلاد من مردود تسويقه
سنة البطاقة1360:
كانت الناس تسمي العام بالأحداث التي قد تذكر الناس بها وتنقلها بواسطة هذه التسمية إلى الأجيال لكي يتعرفوا عليها من خلال هذه التسمية التي توحي بأهم حدث كان إلى الناس المعاصرين لها ، مثل سنة البطاقة ، فسنة البطاقة حدثت عام 1360 هـ بسبب حصار المحيطات والبحار التي توصل بواسطتها وسائل النقل البحرية جميع المواد الغذائية للقطيف من أنحاء العالم والذي كان لا يستطيع أحد أن ينفذ من خلال البحر بشيء أبداً لأن الحرب العالمية الثانية قائمة على قدم وساق ، مما أدى إلى ندرة المواد الغذائية والاستهلاكية والضرورية وانعدامها تقريباً من الأسواق فما يحتاجه الإنسان لم يجده بأضعاف الأثمان حتى بلغ مثلاً فنجان القهوة فاضياً بخمسة ريالات وقلة التمر الواحدة (وزنها اثنين وثلاثين كيلواً) بأربعين ريالاً بالرغم من قلة الدخل وعدم تنوع مصادره، ولكن متى وجد عند من يملك القلال شيء لا يستطيع أن يتصرف فيه إلا خفية لكي لا يراه أحد من الناس فيبلغ عليه الحكومة التي فرضت على الملاكين بيعه عليها لطرح التمور في الأسواق بالبطاقة لكي يباع على الناس بالرطل حسب أعداد أنفس الأسرة من أجل أن لا يموتون جوعاً في كنفها ، إذ الرز والسكر والدقيق وغيرها لم تكن متوفرة في البلاد وإنما الجريش والتمر هما المبسطان في السوق بالبطاقة من قبل الحكومة بأثمان موحدة وأسعار مقبولة وبتقنين البيع لعموم الفائدة وتغطية عجز الأطعمة لكي لا يحرم الفقير ويتمتع الغني مما جعل توزيع المواد الغذائية (خصوصاً حب الجريش والتمر) مقنناً لإعطاء كل حسب أعداد العائلة لا حسب الوجاهة أو وجود المال الذي لا يفيد ذلك الوقت من اقتناه ، فالمال عند بعض الناس متوفر ولكن الأطعمة شحيحة جداً ، وما يفيده المال الذي لا يحصل به على طعام يومه مما جعل الأستاذ الكوفي يمثل هذه السنوات بالسبع الشداد العجاف التي كانت في عهد عزيز مصر كما ذكرها الله عزَّ وجل في محكم القرآن الكريم إذ يقول الكوفي في قصيدته



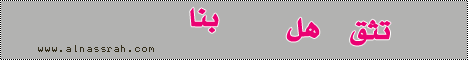



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
المفضلات